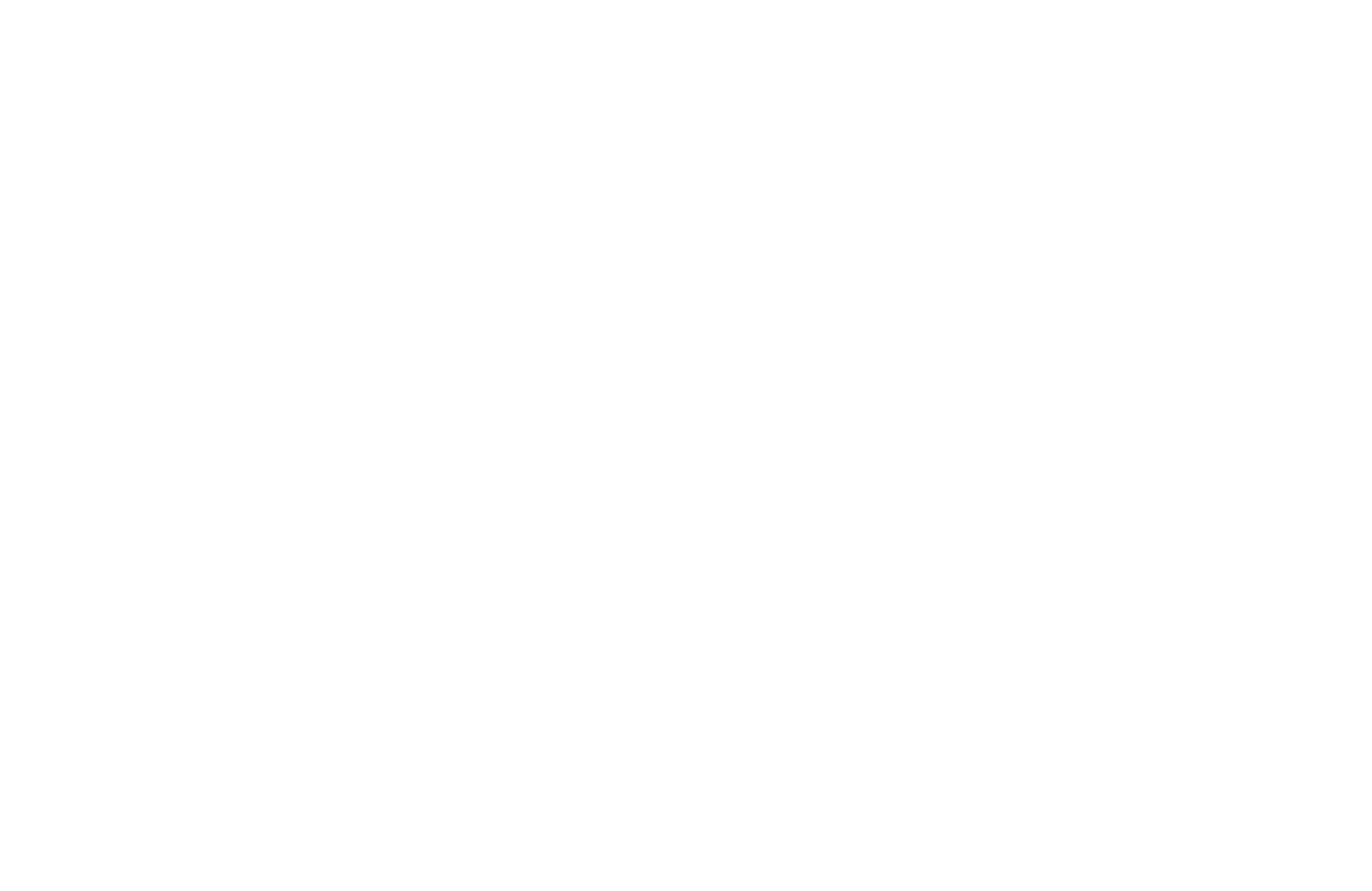مقالات
**
زيارة ولي العهد إلى الويلات المتحدة الأمريكية:
زيارةٌ تتجسد فيها الحكمة والوطن و مصالح الأمتين
الأستاذ المحامي أحمد محمد الأحمد - رئيس تحرير مجلة الامتثال القانونية السعودية
__
في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 — وهو أول حضور له في واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب — بدا المشهد كأنه ذروة مسار طويل من البراغماتية السعودية: استقبال احتفالي لافت في البيت الأبيض، قمم ثنائية، وعقود واستثمارات ودفاع وتقنية تعود إلى صدارة العلاقة. لكن أهمية هذه الزيارة لا تختصرها الصور ولا الأرقام، بل تكمن في الفلسفة السياسية التي سمحت للرياض أن تتعامل مع واشنطن رغم تناقضات رؤسائها، وتقلب خطابهم، وأحياناً ابتذاله. لأن السياسة السعودية في جوهرها لم تُبنَ على الرهان على شخصٍ في البيت الأبيض، بل على فهمٍ بنيوي لطبيعة الولايات المتحدة نفسها: دولة مصالح، مراكز قوى متعددة، ورؤساء يأتون ويذهبون بينما الدولة العميقة — بمؤسساتها وسوقها وتحالفاتها — تستمر.
من المفيد أن نبدأ من الفكرة البسيطة: الولايات المتحدة ليست تسير على نمط واحداث بل هي منظومة متشابكة من المؤسسات التي تتعارض، و البيت الأبيض على رأسها ،ثم والكونغرس، والبنتاغون، والخارجية، والأجهزة الاستخبارية، والإعلام، والقطاع الخاص — وكل طرف له أولويات مختلفةً، لذلك فمن المفهوم أن تسمع في واشنطن خطابات متناقضة في العام نفسه، وربما في اليوم نفسه.
يتعامل رؤساء الولايات المتحدة مع المملكة وفق طريقة تفكير مركّبة تحمل دائماً ثلاثة أبعاد رئيسية: المنفعة، والضغط، والاعتراف الصامت بالوزن الحقيقي للسعودية، ورغم اختلاف الشخصيات بين ترامب وبايدن وأوباما وغيرهم، يبقى نمط التفكير الأمريكي تجاه الرياض ثابتاً في جوهره مهما تغيّر الخطاب أو تبدّل المزاج الانتخابي، غير أن ترامب — بخلاف مرحلة ولايته الأولى — قدّم البعد الثالث بوضوح أكبر، لأنّه تعلّم الدرس: اكتشف أن السعودية ليست دولة يمكن مخاطبتها بمنطق الابتزاز السياسي أو التهويل الانتخابي، بل قوة إقليمية ودينية واقتصادية تملك خيارات متعددة، وأن احترام هذا الوزن هو المدخل الوحيد لبناء علاقة ناجحة معها. ولذلك جاء سلوكه في ولايته الثانية أكثر نضجاً: حفاوة، تقدير علني، واستجابة للتصورات السعودية في ملفات مثل سوريا والسودان والطاقة، في دلالة على فهم أعمق لطبيعة المملكة، وعلى قناعة بأن احترام مكانتها لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية لأي إدارة أمريكية
ونذكر هنا كيف حضَّرت المملكة مبكراً لإدارة بايدن وتوقعت منذ البداية ترشّحه وفوزه المحتمل، فتعاملت معه قبل وصوله إلى البيت الأبيض كمعطى سياسي يجب استيعابه، لا صدمة يجب مقاومتها. وعلى خلاف ما ظنه البعض، لم تفاجأ الرياض بخطابه الانتخابي الحاد ولا بتعهداته المتوترة، بل قرأت تلك التصريحات ضمن سياقها الطبيعي في الحملات الأمريكية، حيث تُستخدم الملفات الخارجية لكسب أصوات الداخل. وبدلاً من الاكتفاء بالتوتر أو الانفعال، بدأت السعودية بإعداد ملفاتها، وتعديل نبرة خطابها، وترتيب قنواتها الدبلوماسية، وتقديم رسائل هادئة تشرح موقفها وتعرض رؤيتها للمنطقة. وعندما وصل بايدن إلى الحكم، لم تستقبله المملكة بردود فعل دفاعية، بل بواقعية راسخة، تعاملت معه وفق ما تقتضيه المؤسسات الأمريكية لا ما تقوله المناظرات. وهكذا تحولت اللحظة التي توقع كثيرون أن تكون بداية صدام، إلى مساحة جديدة لتثبيت مكانة السعودية وتعزيز علاقاتها ضمن فهم عميق لطبيعة السياسة في واشنطن
منذ سنوات كانت السعودية تدرك أن الاعتماد على الودّ الشخصي وحده مع الرؤساء لا يكفي ، ولا يمكن التعويل عليه!! فالعلاقة الشخصية مهمة ولكن السعودية تُوضعها كأداة ضمن أدوات يتم التعاطي معها، لا كأساس وحيد، لذلك اتجهت السياسة السعودية إلى ثلاثة مسارات متوازية:
1) تثبيت المصالح الاستراتيجية الطويلة
الأمن الإقليمي، توازن الردع مع إيران، أمن الطاقة، مكافحة الإرهاب، واستقرار طرق التجارة. هذه ملفات لا يستطيع أي رئيس أمريكي تجاهلها طويلاً، مهما بدأ حملته بلغة العقاب.
حتى في ذروة التوتر مع إدارة بايدن، لم تُرفع “الأسس الصلبة” للعلاقة، لأنها جزء من بنية الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط.
2) نقل العلاقة من “نفط وسلاح” إلى “اقتصاد وتقنية ومستقبل”
زيارة 2025 جاءت في لحظة تحوّل عالمي: الذكاء الاصطناعي، سلاسل توريد المعادن النادرة، الطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم.
ولهذا كان عنوان الزيارة مركزاً على استثمارات قد تصل إلى قرابة تريليون دولار في الولايات المتحدة، مع تركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التقنية — وهو ما أعلنته وسائل أمريكية وعربية عدة.
حين تنقل السعودية العلاقة إلى مستقبل الاقتصاد الأمريكي نفسه، تصبح هذه العلاقة دالةً على الداخل الأمريكي لا على الخارج فقط. أي رئيس سيجد نفسه مضطراً للتعامل معها باحترام أكبر، لأن الكلفة السياسية على الاقتصاد والوظائف تصبح عالية.
3) توسيع شبكة العلاقة داخل أمريكا (وليس مع الرئيس فقط)
السعودية تركز على المصالح ومراكز القوة الأخرى:
فشركات التقنية والدفاع، ومراكز المال، والكونغرس بمستوياته هو من يحرك القرى فأمريكا في النهاية دولة مال ، والسعودية — بحكم تجربتها مع القوى الكبرى — تتعامل مع السياسة الدولية كـ”سوق قوى”، لا كـ”ساحة وعظ”.
إن ما تتبعه المملكة نهج يقوم على أنها دولة ذات نفوذ واسع ومصالح ممتدة، مما يجعل بناء التوازنات مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا والهند وأوروبا ضرورة استراتيجية. فالسعودية تحتاج هذا التنوع في الشراكات، ولا يُتصوَّر عقلاً أن ترتبط بمحور واحد أو تحصر خياراتها في دولة بعينها، لأنها دولة بحجم يتطلب شبكة علاقات متعددة تحفظ مصالحها وتدعم استقلال قرارها. ويتم كل ذلك دون تعارض أو تضاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل ضمن منظومة علاقات متوازنة ترى أن توسيع دائرة الشراكات لا يعني القطيعة مع الحلفاء التقليديين، بل يعكس نضج دولة تعرف كيف تدير مصالحها في عالم متعدد الأقطاب
في زيارة 2025 ظهرت ملامح هذا التوازن بوضوح، فالإدارة الأمريكية سعت لعقد صفقات دفاعية كبيرة، و هذا النوع من الصفقات لا يُقدَّم عادةً إلا لدول”صاحبة قرار وتستطيع خلق خيارات أخرى، والاستقبال الحافل في واشنطن لم يكن مكافأةً أخلاقية، بل اعترافاً عملياً بثقلٍ يرمم صورة العلاقة أمام الداخل الأمريكي ويظهر السعودية كشريك اقتصادي مستقبلي.
هذا كله يفسر لماذا بدا اللقاء “تاريخياً”:
لأنه جاء باعتباره حصيلة مسار سعودي طويل لاختبار واشنطن، وأخذ المسافة اللازمة منها، ثم العودة إليها ، وإذا أردنا تلخيص الفلسفة السياسية السعودية تجاه أمريكا في جملة واحدة فهي:
“نحترم أمريكا كقوة كبرى، لكننا لا نُؤلّه رؤساءها، ولا نرهن مستقبلنا بمزاجهم؛ نتعامل مع الدولة لا مع الخطاب، ومع المصالح لا مع الانفعالات.
ومن الواجب التأكيد على أحد أهم المفاتيح لفهم الفلسفة السياسية السعودية في علاقتها مع الولايات المتحدة هو إدراك الفارق الجوهري في نطاق المسؤولية الذي تتحمله كل دولة، فالولايات المتحدة، بحكم بنيتها السياسية والانتخابية، تنظر إلى العالم من زاوية مركزها الداخلي:
• كيف يؤثر ذلك على الناخب؟
• كيف يمكن استخدام الملف الخارجي لكسب دعم قاعدة سياسية؟
• كيف ينعكس هذا القرار على الاقتصاد المحلي، الوظائف، وولاءات اللوبيات؟
هذه النظرة “الداخلية الصرفة” مألوفة في الديمقراطيات، لكنها تنتج سياسة خارجية أنانية بطبيعتها؛ لا ترى إلا مصالحها هي، ولا تتحرك إلا بمقدار ما يخدم الداخل الأمريكي.
في المقابل تتحرك السعودية من موقع مختلف بالكامل، و تتحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً ودينياً يخص العالمين العربي والإسلامي، ولذلك حين تدخل السعودية أي حوار أو تفاوض أو أزمة مع الولايات المتحدة، فهي لا تحمل “مصالحها فقط”، بل تحمل:
استقرار العالم العربي الإسلامي
— بحكم وجود الحرمين، وبحكم موقع المملكة الروحي والسياسي الذي يجعل من كل خطوة خارجية قراراً له أصداء عابرة للحدود.
تشير مؤشرات متعددة إلى أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان صاحب تأثير مباشر في دفع الولايات المتحدة، خلال فترة ترامب، إلى إعادة النظر في الملف السوري من زاوية جديدة تعتمد على توظيف الدولة السورية — بعد إعادة هيكلتها سياسياً — كعنصر استقرار إقليمي قادر على المساهمة في القضاء على الإرهاب والميليشيات العابرة للحدود. فقد نقلت تقارير سياسية أن السعودية قدّمت لواشنطن تصوراً يقوم على أن استمرار الفراغ في سوريا هو ما يسمح لتنظيمات التطرف والميليشيات المدعومة خارجياً بالتمدد، وأن إعادة إدماج دمشق في النظام الإقليمي — ضمن معادلة رقابية وضابط إيقاع عربي — يشكل خطوة أكثر فاعلية من بقاء العقوبات والسياسات العقابية التي أثبتت محدودية أثرها. ويبدو أن هذا الطرح وجد صدى لدى ترامب، الذي أكد أن جزءاً من قراراته تجاه سوريا جاء بناءً على طلب سعودي، مما يدل على أنّ واشنطن بدأت ترى دمشق ليس فقط كملف نزاع، بل كأداة يمكن — إذا وُضعت ضمن إطار عربي مقنّن — أن تسهم في كبح التطرف، وضبط الميليشيات، وإعادة الاستقرار للمشرق. هذا التحول يعكس نجاح الرياض في إعادة صياغة القراءة الأمريكية للمنطقة من “معالجة الأزمات” إلى “بناء الدولة” كحل أعمق وأطول مدى.
ولأن المملكة تتحمل مسؤولية تتجاوز حدودها كما أشرت ، وتحمل همّ العالم العربي والإسلامي في مقاربتها للأزمات، جاءت مطالبتها للولايات المتحدة بالتدخل الدبلوماسي الفاعل لوقف الصراع في السودان باعتبار أن ما يجري لم يعد مجرد نزاع مسلّح، بل سلسلة متواصلة من القتل والاغتصاب والانتهاكات والجرائم اليومية التي تهدد بتدمير المجتمع السوداني من الداخل. وترى السعودية أن المطلوب هو إنهاء مأساة السودانيين دون تقسيمهم أو الدفع ببلادهم نحو خرائط جديدة تزيد الفوضى، أو صناعة اصطفافات تُغذّي الانقسام الأهلي. فالمملكة تدرك أن تفكك السودان ليس خطراً محلياً فقط، بل تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر، واستقرار القرن الأفريقي، وتوازن الإقليم بأكمله. ومن هنا، رأت الرياض أن التدخل الأمريكي — بما تمتلكه واشنطن من أدوات ضغط وتأثير — يمكن أن يشكل دعامة إضافية للجهود العربية في فرض وقف للانتهاكات، وإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية تحافظ على وحدة السودان وسلامة شعبه. كانت مطالبة المملكة تعبيراً عن مسؤولية سياسية وأخلاقية ترى أن حماية المدنيين، ومنع الجرائم اليومية، والحفاظ على السودان موحداً، مهمة لا يمكن تأجيلها.
وهذا كلّه ما فاض به الإعلام والتحليلات الدولية، دون أن تُصرّح المملكة علناً بأنها تسعى لحل هذه الملفات أو تقودها بصورة مباشرة، فالسعودية بطبيعتها لا تتعامل بمنطق الاستعراض السياسي، ولا تُعلن عمّا تعمل عليه قبل نضجه. لكن المؤشرات وحدها تكشف أن جعبة المملكة مليئة بما يخدم مصالحها ومصالح محيطها العربي والإسلامي؛ أفكار، مبادرات، اتصالات، وحلول تُدار بهدوء خلف الكواليس، وتظهر نتائجها حين يشتدّ المشهد أو تصل الأطراف إلى طريق مسدود. فالسعودية تعمل بعقلية الدولة التي تحمل مسؤولية أكبر من حدودها، وتدرك أن قوتها لا تُقاس بما تُعلنه، بل بما تُنجزه فعلياً، وبقدرتها على التأثير في الملفات الكبرى من دون ضجيج أو إعلان.
ما يفسّر الغضب الإسرائيلي مؤخرا أن الولايات المتحدة نفسها لم تعد ترى ملف التطبيع كأولوية مطلقة، بل كـ إحدى المشكلات المؤجلة التي لم تُحل بعد، ولن تتوقف واشنطن عندها إذا تعارضت مع مصالحها الأكبر. فالأمريكيون، بطبيعتهم السياسية، يميلون دائماً إلى تقسيم المشاكل وتجزئة الحلول؛ يحددون ما يمكن التعامل معه الآن، وما يمكن ترحيله، وما يمكن تجاوزه بالكامل. ومن هذا المنطلق بدأت تتعامل واشنطن مع إسرائيل والتطبيع باعتبارهما ملفاً غير مكتمل، لكنه ليس من النوع الذي يستدعي تعطيل الشراكات الأهم. فالمصالح الأمريكية اليوم تتأثر مباشرة بالاستقرار الإقليمي، وأمن الطاقة، والبحر الأحمر، والذكاء الاصطناعي، والعلاقات مع الخليج، وهي مجالات تتصدرها السعودية. ولذلك لم تعد الولايات المتحدة مستعدة لربط تقدمها في هذه الملفات الحساسة برغبات إسرائيل أو حساسياتها السياسية. هنا بالتحديد بدأت تل أبيب تشعر بأن وزنها يتراجع، لأن واشنطن — عملياً — تجاوزت العقدة الإسرائيلية، وأدركت أن المستقبل الإقليمي لن يُبنى على إرضاء طرف واحد، بل على تحقيق توازن يخدم مصالحها هي أولاً.
هذه المصالح العربية والإسلامية هي ما يجعل المواقف السعودية — حتى في أحلك لحظات التوتر مع واشنطن — غير انفعالية وذات مدى استراتيجي طويل، وحين يتخذ الرئيس الأمريكي موقفاً خاطئًا ضد السعودية، يفكر في الداخل ، ولكن في المقابل حين تتخذ السعودية قراراً، تفكر في أمّتين، وفي مئات الملايين من المسلمين والعرب الذين يتأثرون بأي تغير في موازين القوى.
هذا الفارق ليس مجرد “ملاحظة”، بل مؤشر فلسفي يشرح لماذا تلتزم المملكة بضبط النفس، وتجنّب التصعيد، وإدارة العلاقات — حتى حين تتعرض لمواقف غير مفهومة أو مرضية ، أو انتقادات غير عادلة من الإعلام الغربي، أو حتى العربي.
وحين تقرأ استقبال 2025 التاريخي، فإنك لا تقرأ مجرد بروتوكول، أو لحظة دبلوماسية عابرة، بل تقرأ نجاحاً سياسياً متراكماً، واعترافاً دولياً بأن السعودية دولة ذات مسؤوليات تتجاوز حدودها، وصاحبة دور إقليمي ودولي لا يمكن تجاوزه. ورغم كل ما تُظهره الولايات المتحدة من تبدّل في الخطاب، أو ضغوط في المواقف، تبقى المملكة ثابتة في موقعها، محافظة على تماسك حضورها، وفرض احترامها على الجميع. وهذه المكانة لم تأتِ صدفة، بل كانت توفيقاً من الله، ثم حكمة في إدارة الدولة، وحسن تقدير للخطوات، واتزاناً في قراءة الأحداث. وهكذا تظل المملكة تتقدم بثقة، وتُثبت للعالم أن الاحترام لا يُطلب، بل يُصنع عبر القوة الرشيدة، والرؤية الواضحة، والسياسة التي تعرف قيمتها، وحدودها، وغاياتها